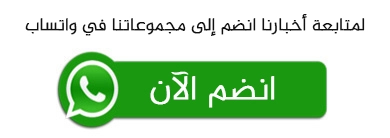بُعْد ومسافة
خلال الأيّام الأولى لنجاح الثورة وإنتفاضة الشّباب ضِدّ نظام الإنقاذ ، وفي صالة التحرير داخل مقر الصحيفة التي كنت ارأس تحريرها في ذلك الوقت ، دارَ نقاشٌ واسِعٌ بين عددٍ كبيرٍ من المحرّرين وكُتّاب الأعمدة ، حول الأوضاع التي تعيشها بلادنا آنذاك ، والتي من المتوقّع أن تعيشها بعد الثورة ، تعلو أصواتُ الشّبابِ بإنفعالٍ شديد ، ويحاولون أن يستنْصِروا بغيرهم لدعم آرائهم ومساندتهم ، بينما تعلو أصواتُ مخالفيهم حول ذات القضايا ، وعندما سألني بعضهم عن رأيي والمقارنة بين الثورات الكبرى التي شهدها السودان المستقل بعد أن تسلّم الوطنيون مقاليد الحكم ، قلت لهم إنّ الثورات السودانية الحديثة الكُبْرَى المتمثِّلة في ثورة أكتوبر 1964م ، وأبريل 1985م .
وثورة الشباب الأخيرة في ديسمبر 2019م التي تُوِّجت مثل سابقتيها بأنحياز القوات المسلحة للشعب السوداني ، هي ثوراتٌ ناقصة ، بدليل أن ذات الخارجين على الأنظمة والثائرين عليها يعودون بعد سنوات يتباكون ، و (يهتفون) حسرة على تلك الأيام مثلما حدث لحكومة الفريق إبراهيم عبود – رحمه الله – وقد هتفَ النّاس بعده (ضيّعناك وضِعنا معاك يا عبود) ومثلما حدث عقب إسقاط النظام المايوي بسنوات حتى أن الإستقبالات الشّعبية التي حُظِي بها الرّئيسُ الراحل المشير جعفر نميري عند عودته من منفاه في مصر ، كانت إستقبالات قلَّ أن يُحْظَى بها بطلُ حربٍ أُسطوري حقّق ما لم يحققه أحد لبلاده .
ذكرتُ للزملاءِ الأفاضل أن المُشْكِلة في حقيقة الأمر ليست مُشكِلة السُّودان وحده ، بل هي مُشْكِلةٌ تواجه كُلّ القارة الإفريقية لأن الحدود القائمة بين الدول هي حدود مصطنعة ، لم تُراع التداخل القبلي والأثني والعرقي بعد تقسيم القارة عقب مؤتمر برلين المنعقد في الحادي عشر من نوفمبر 1884م ، والذي أغفل الإعتبارات التاريخية والإجتماعية والثقافية من خلال محاولة فرض الدولة القومية على أساس تلك الحدود التي إعتمدتها الدُّولُ الإستعمارية وفقاً لمصالحها وقدراتها العسكرية .
وهو ماجعل – بعد زيادة الوعي في القارة – البعض يتّجه نحو الإعتماد على القبليّة كمكوّن إجتماعي وسياسي تقليدي ، وهو ذات ما إتجهت له القبائل الكبيرة العابرة للحدود ، وهو إعتماد برنامج سياسي قبلي كبير لا يعترف بالحدود ، على إعتبار أن القبيلة هي المؤثر الأساسي في القرار السياسي .
ذلك المفهوم أدّى إلى أن تنشأ الدول الأفريقية – ربما باستنثناء دولة أفريقية واحدة – وهي تحمل عوامل فنائها داخلها ، وأدى في ذات الوقت إلى أن تشعر المؤسسة العسكرية ممثلةٌ في مؤسسات الجّيشِ والشرطةِ والأجهزةِ الأمنية بأنها الوحيدة التي تُعبِّر عن كُلِّ الناس لقوميتها ولوصفها وفق التعبير الغربي الأشهر بأنها المؤسسة الشرعيّة الوحيدة المفوضة بإحتكار السِّلاح وإستخدام العنف … لذلك كانت الإنقلابات إحدى السِّمات البارزة في القارة الأفريقية.
دخلت عناصر جديدة لتكون ضمن العناصر المؤهلة للحكم في البلاد ، ومنها التيارات العقائدية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ، ومنها التّمرد على الدولة القديمة الناشئة وفق المصالح الإستعمارية ، ومنها الإستيلاء والسّيطرة على النّقابات ومنظمات المجتمع المدني كوسائل ضغط على الحكومات ، وهو ما أفرز ولو بصورة غير مباشرة ما يمكن أن تنطبق عليه شروط الدولة الفاشلة .
مثلاً … دولة مثل السودان كان أسهل قرار بالنسبة لمواطني إقليم واحد هو الإنفصال بعد أن تمّ العرض من خلال إستفتاء عام ونقصد إنفصال جنوب السودان رغم الإتفاقية الموقّعة بين أطراف الصراع عام 2005 م ، ولكن كل طرف كان ينظر للإتفاقية بعين غير عين الآخر.
الدولة القومية التي نسعى إليها جميعاً لابد من أن تستند على شعبٍ ذي هوية سياسية متفقٌ عليها ، وتجمع بين مواطنيها وشائج خاصة لغوية وروحية ووجدانية تميزهم عن بقية الشعوب الأخرى.
الدولة القومية الحديثة يجب أن تستصحب ضرورة تغيير المفاهيم ، ولابد أن يتفق قادتها وحكماؤها ومفكروها وساستها على تغيير المفاهيم القديمة البالية والرجعية – سمّها ما شئت – ولابد من الإتفاق على مزيج خاص يصبح هو المزاج العام لمواطني الدولة ، ويضع الأُسس الموضوعيّة لحُكم الدولة ، لا الأسس غير الموضوعية لِمَنْ يحَكُم الدّولة .
لقد إنتهى عالمياً عهد الأحزاب التقليدية ، هناك أحزابٌ جديدة تطرح البرنامج والمشروع السياسي الجيد الذي يلتف حوله الناس .